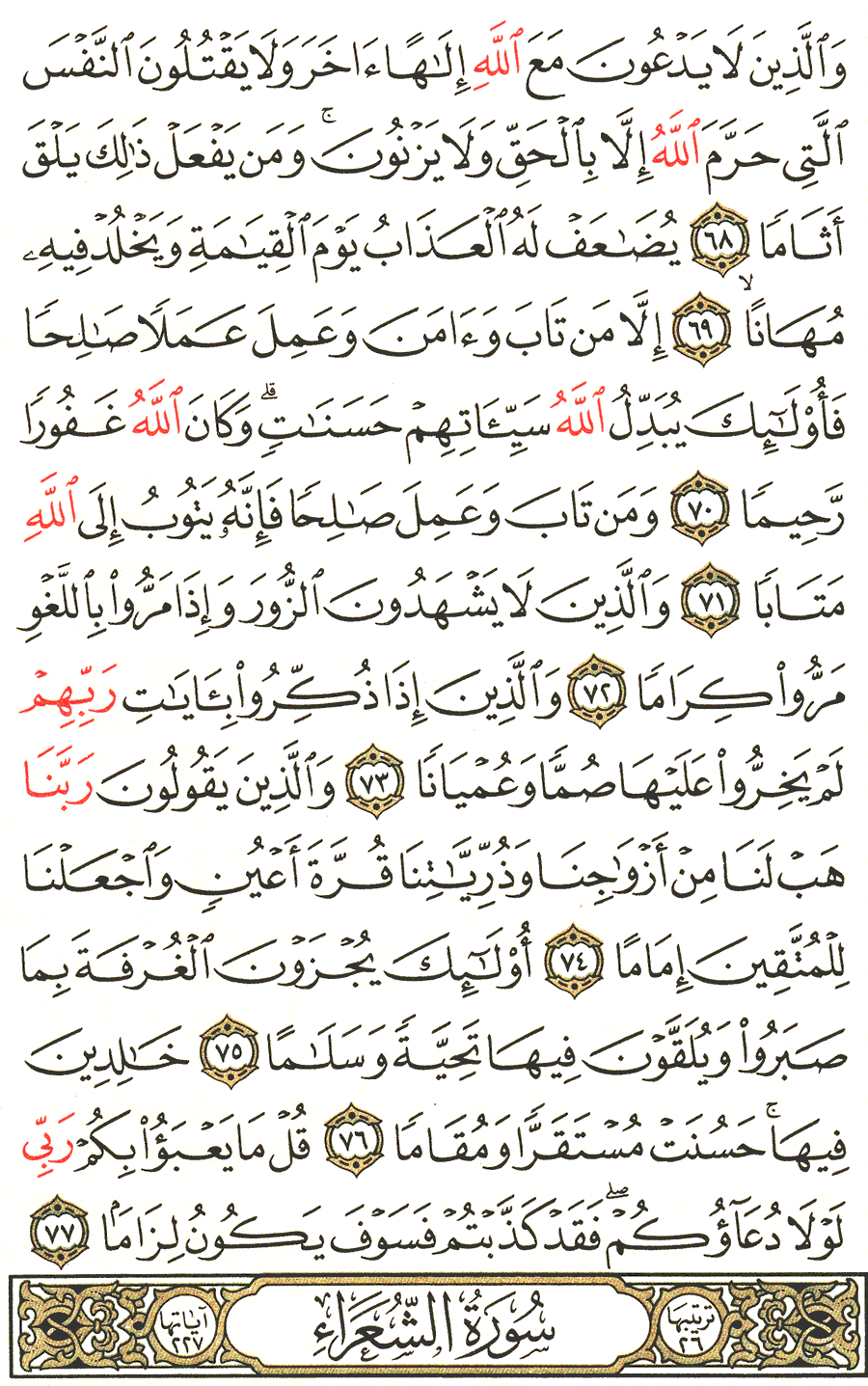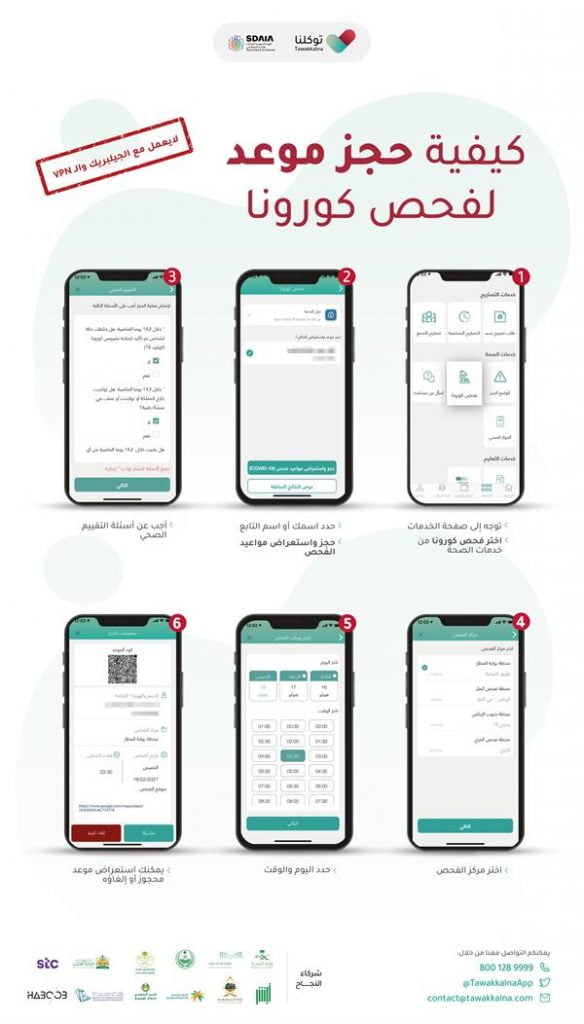هو كل ماله قيمه باقة من عادات واداب وعلوم - هو كل ما له قيمة باقية من عادات و اَداب وعلوم وفنون وحرف وغيرها وينتقل من جيل إلى جيل
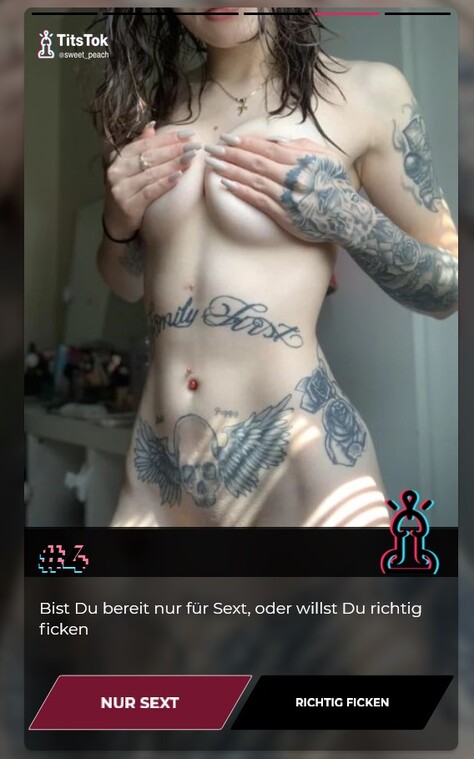
Recent Posts
- كيف استخرج شهادة الثانوية
- استقبال القبلة عند قضاء الحاجة حكمه بيت العلم
- المناخ، والزمن من العوامل المؤثرة في تكون التربة .
- مبخرة ابيات
- الطقس
- تدريب صيفي 2021
- البكاء على الميت في المنام
- صناعة في اليد أمان من الفقر
- سبب تأخر الدورة الشهرية للعزباء
- فيسبوك بحث
- كفل الرسول صلى عليه وسلم جدّه عبدالمطلب مدة
- كلمه عن يوم التاسيس
- يوسف ماجد الكدواني
- الطيران المصري
التراث الشعبي هو كل ماله قيمة من عادات واداب وعلوم وفنون وحرف تنتقل من جيل الى جيل
فرَّقت بيننا الأيام وسافر في العام التالي مع بعثة الجامعة، ولما آب من سفره انتظم في سلك أساتذتها وأنشأ يكتب في مجلة السفور قطعًا باهرة، أذكر منها رواية بعنوان «هي» كتب منها نحو سبع قطع ولم يتمها، كان فيها الوصف بالغًا حده من الدقة وحسن التصوير، والعواطف تلتهب التهابًا بأسلوب ظريف لا يشوبه تكلف، تزينه رشاقة جذابة ورقة فتانة.
وأظن أنه قد سبق لي أن حدثتكم في نفس هذا المكان عن البدوية التي صادفتها في طريق قفر في «خروميري» ولم تدرِ أني أنظر إليها وهي مارة، وكانت تتقدم في رياح الخريف بين أوراق الخريف المتناثرة وعصاها بيدها، وهي تقطع ألحان الشكوى التي كانت تبتكرها وهي سائرة يخنقها البكاء والتنهدات، وحينما استعلمت عنها قيل لي: إنها تقطع وحدها أوزان الآلام؛ لأنها شاهدت المحضر الإفرنجي وهو يبيع أمتعتها الحقيرة.
عادات وعلوم واداب تنتقل من جيل الى اخر من 6 حروف
ومعروف أن الشيخ سلامة ترك شركة إسكندر فرح وإخوته من ثلاثين سنة تقريبًا؛ أي قبل مجيء الكاتبة إلى مصر بثمان سنوات، وفي عهد زيارتها لمصر كان الشيخ سلامة وحده صاحب المسرح، فأين إذن هذه الشركة السورية المسيحية الموهومة والممثل السوري الأول؟ وهل يعقل الصبيان أن كل هذه الجموع لم يوجد فيها فرد ينظر إلى المسرح، فلم إذن جشموا أنفسهم السهر والانتقال من أنحاء القاهرة وضواحيها البعيدة وأنفقوا ثمن التذاكر وأجر الانتقال؟ ولنفرض جدلًا أن في هذا الافتراء أثر من الحقيقة يصدق على بعض أفراد يعدون على أصابع اليد، فهل هذا خير أم ما يقترفه الباريسيون في أكبر التياترات، والذي وصفه «فكتور مارجيريت» في رواية «المتفتية la Garconne» أو «الغلامية» إن أردت مما أخجل أن أذكره للقراء.
إنه يتهلل لجمال الطبيعة وقد جللها النور وكستها أزهار الربيع بشائق حللها، ويشجيه تغريد الطير فوق الدوح والخمائل، ويبسم لقوس قزح، ويفتنه جمال الزهر ويثمله أرجه العبق، ويصغي بفرح إلى خرير الأمواج ومداعبتها للسفن الماخرة، وقد عبر عن هذا الشغف في كثير من المواقف؛ كقوله في عرض قريضه: «قد دعيت إلى عيد الدنيا وبورك لي في حياتي.
- Related articles
2022 encompassinc.co